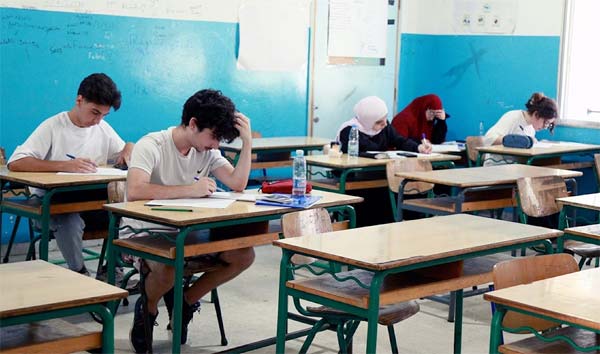محمد ماجد (باحث ومؤلف تربويّ ومتخصّص في بناء المناهج والتعليم الرقميّ) ـ الأخبار
قبل ثلاثة أعوام نشرت «الأخبار» لكاتب هذه السطور مقالة عنوانها: «الآداب والإنسانيّات: فرعٌ إلى زوال» تناولت جانباً من مشكلات التربية في لبنان، مُركِّزاً على الخطر المحدق بفرع الآداب والإنسانيّات في حال استمرار السياسات التربويّة الكارثيّة.
إذ يتناقص عدد المتقدّمين إلى هذا الفرع المظلوم باستمرار، في حين تزيد أعداد المتقدّمين إلى بقيّة الفروع. فمقابل 5199 متعلّماً عام 2004، لم يتجاوز عدد المتقدّمين في الآداب والإنسانيّات اليوم الـ 500، ومن الواضح أننا خلال سنة أو اثنتين سنشيّع هذا الفرع رسميّاً.
أسباب كثيرة كامنة خلف هذا التردّي تتعلق بمشكلات التربية عموماً والامتحانات الرسميّة وآليّات التقييم المعتمدة (واللجان المختارة بعناية طبعاً) التي تفضي إلى نتائج مقنّعة غالباً، ناهيك عن المناهج المعتمدة بعلّاتها منذ 25 عاماً رغم عمل المركز التربويّ على تطويرها.
لكن السطور التالية ستركّز على مشكلة غياب التوجيه، وانكفاء الوزارة عن واجبها، ومسؤوليّة الطاقم الإداريّ والتعليميّ في كلّ ذلك.
يأتي المتعلّم ليسجّل في صفّ الثانويّة العامّة، مجتازاً الصفّ الثاني الثانويّ - فرع العلوم، فتفتح له الفروع الأربعة (العلوم العامّة، علوم الحياة، الاجتماع والاقتصاد والآداب والإنسانيّات) مع بعض الضوابط المرتبطة بأدائه وعلاماته، والتوجّه يكون عادة نحو أحد فرعي العلوم، وإن لم يوفّق فصدر الاجتماع والاقتصاد رحب دوماً. في حين يُسمح للمتعلّم الذي تجاوز الصفّ الثاني الثانويّ - فرع الإنسانيّات بفرع الاقتصاد في حال كانت علاماته في الرياضيّات جيّدة، وإلّا - وهذا الغالب - يُفتح له إلزاماً باب واحد: الآداب والإنسانيّات!
ولكن، لا أحد - إلّا ما ندر - يرغب في الانتساب إلى فرع الآداب والإنسانيّات لأسباب كثيرة، منها أنّه «اختصاص الفاشلين» الذي يخجل منه المتعلّمون وأهلوهم كما انه «اختصاص حفظ»!
لنبدأ بالسبب الأوّل: «اختصاص الفاشلين«! المسؤول مباشرة عن هذا السبب هي الثانويّات الخاصّة والرسميّة، ومن خلفها الوزارة. فالإدارات تعتمد هذا التصنيف: كلّما ارتفع معدّل النجاح في الصفوف السابقة، أتيح للمتعلّم الأعلى فالأعلى، ولا يبقى للمتعلّم صاحب المعدّلات المتدنيّة في الثانويّة العامّة سوى الآداب والإنسانيّات، فيدخلها مرغماً إذا قرّر متابعة التحصيل الدراسيّ. أمّا الوزارة، فليست لها سياسة واضحة في هذا المجال!
وأمّا أنّه اختصاص يخجل منه المتعلّمون، فلأنّه، بالإضافة إلى ما تقدّم من سمعة هذا الفرع، اختصاص لا سوق عمل له، ومآل صاحبه نحو التعليم غالباً. والمسؤول عن هذه المشكلة مرّة أخرى الوزارة وأهلها وأجهزتها الإداريّة والتربويّة، ومن خلفها المجتمع كلّه!
ورغم كلّ الأوهام المتعلّقة باختصاصات الآداب والعلوم الإنسانيّة، ومزاعم عدم حاجة سوق العمل إلى خرّيجيها، فإنّ المعطيات العالميّة اليوم تؤكّد غير ذلك، إذ تشير إلى حاجة السوق المتزايدة إلى الكفايات التي ينتجها هذا الفرع المظلوم. فـ«المنتدى الاقتصاديّ العالميّ» يضع مهارات التفكير النقديّ، والذكاء العاطفيّ، وحلّ المشكلات، في صدارة المهارات الأكثر طلباً حتى عام 2035.
وسوق العمل العالميّ يسير في هذا الاتّجاه فعليّاً، ويطلب من خرّيجي الفلسفة والآداب وعلم النفس واللغات أن يشاركوا في تصميم مستقبل الذكاء الاصطناعيّ، وصياغة الخطاب الثقافيّ، وبناء السياسات الإعلاميّة والتعليمية الجديدة. وتشير الأرقام إلى أنّ الطلب على وظائف من مثل الكتابة المهنيّة والإبداعيّة، والتحليل السلوكيّ، وتصميم المحتوى بأنواعه الكثيرة، وتعليم المهارات الفكريّة والمعرفيّة، يشهد نموّاً سنويّاً ثابتاً يراوح بين 10 و30% عالميّاً، فيما تستحدث الجامعات الكبرى تخصّصات جديدة تدمج بين العلوم الإنسانية والتقنية.
يعمل كاتب هذه السّطور في مجال بناء المناهج والتأليف التربويّ، والكتابة الإعلاميّة، ونبحث دائماً عن أكفاء يعملون، فنجدهم غالباً بعد عسر كبير، بعيداً من حملة شهادات الاختصاص، من الهواة والموهوبين! وفي ما يأتي، ومن باب التذكير، مجموعة من التخصّصات الجامعيّة الّتي تتيح عملاً مطلوباً للمتخصّصين في العلوم الإنسانيّة:
- الترجمة واللغات الأجنبية: الترجمة الفورية والتحريرية، العمل في المنظمات الدولية، شركات متعددة اللغات، الإعلام، النشر، التعليم...
- الصحافة والإعلام الرقميّ: الصحافة المكتوبة والمرئية، إدارة المحتوى الرقمي، التدوين، البودكاست، العلاقات الإعلاميّة.
- العلاقات العامة والإعلان: شركات الإعلان، إدارات الاتصال المؤسسي، تنظيم الحملات الترويجية، العلاقات الحكومية.
- التسويق والتسويق الرقمي: التسويق عبر الإنترنت، تحليل السوق، بناء العلامات التجارية، إستراتيجيات المحتوى.
- الكتابة الإبداعية وكتابة المحتوى: كتابة النصوص الأدبية، النصوص الإعلانية، المحتوى الرقمي، كتابة السيناريو، النشر.
- العلوم السياسية والعلاقات الدولية: الديبلوماسية، مراكز الدراسات، المنظمات الدولية، الإعلام السياسي، تحليل السياسات.
- الفلسفة التطبيقية والأخلاقيات: البحث الأكاديمي، استشارات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والطبية، التدريس، السياسات العامة.
- علم النفس التطبيقي: الاستشارات النفسية، الموارد البشرية، بحوث السوق، تطوير الأداء، الصحة النفسية.
- علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية: العمل في المنظمات غير الحكومية، التنمية الاجتماعية، البحث الميداني، السياسات الاجتماعية.
- إدارة الموارد البشرية: التوظيف، تطوير الكفاءات، تقييم الأداء، علاقات العمل.
- الدراسات الثقافية والأنثروبولوجيا: البحث الأكاديمي، العمل في المنظمات الثقافية، التراث، تطوير السياسات الثقافية.
- تصميم المناهج والتربية الحديثة: تصميم البرامج التعليمية، التدريب، تطوير المحتوى التعليمي الرقمي.
- الآثار والمتاحف والسياحة الثقافية: العمل في المتاحف، الإرشاد السياحي، البحث الأثري، إدارة المواقع التراثية.
- الفنون المسرحية والسيناريو والإخراج: الإنتاج المسرحي والسينمائي، كتابة السيناريو، الإخراج، التعليم الفني.
- دراسات النوع الاجتماعي والتنمية: العمل في التنمية، حقوق الإنسان، المنظمات غير الحكومية، البحث الاجتماعي.
- إدارة المؤسسات الثقافية والإعلامية: إدارة المتاحف، المراكز الثقافية، دور النشر، المؤسسات الإعلامية.
- القانون: المحاماة، القضاء، الاستشارات القانونية، العمل الحكومي.
- العمل في المنظمات غير الحكومية والتنموية: تنسيق البرامج، إدارة المشاريع، التدريب، تطوير المجتمع.
- تحليل الخطاب والتواصل الإستراتيجي: تحليل وسائل الإعلام، العلاقات العامة، استشارات الاتصال، الحملات السياسية.
- ريادة الأعمال الثقافية والإعلامية: تأسيس مشاريع ثقافية، شركات إنتاج إعلامي، منصات تعليمية وإبداعية.
من البديهيّ أن يقال هنا إنّ هذه التخصّصات تتطلّب مهارات عالية من المتعلّم، والمناهج وطرائق التعليم الحاليّة لا تتيحها، وهذا صحيح. ويزيد من المشكلة عقليّة شريحة كبيرة من الطاقم التعليميّ الّتي لم تتجاوز صورة التعليم التلقينيّ، ولم تطوّر مهارات التعليم أو تتابع ما يستجدّ من تطوّر هائل في العالم... المشكلة تعود مرّة أخرى إلى الوزارة، فلا هي تختار المعلّمين بطريقة صحيحة، ولا هي تعمل على تطوير كفاءاتهم (هل نتحدّث عن دورات التطوير التي يحتاج مدرّبوها إلى دورات تطوير؟).
أمّا أنّ هذا الفرع يتطلّب الحفظ، فهنا داهية الدواهي! وكأنّ كلّ الكفايات التعليميّة التعلّميّة القائمة على التفكير الناقد، والمنطقيّ، ومنهجيّة البحث العلميّ، والاستدلال... ليست من العلوم الإنسانيّة في شيء!
والمصيبة تشمل معظم المواد، ولكنّها تبرز في أكثر المواد التي تتطلّب إعمال العقل والتفكير المنطقيّ: الفلسفة! هذه المادّة الرائعة تقدّم للمتعلّمين - غالباً - على أنّها محفوظات على المتعلّم أن يخزّنها في ذاكرته ليسكبها على ورقة الإجابة في الامتحان، ثمّ لا يفهم منها شيئاً ولا يفيد من حافزيّتها التفكيريّة والمعرفيّة النقديّة شيئاً!
وماذا نقول عن دروس التاريخ والجغرافيا؟ أمّا اللغة والأدب، فحدّث ولا حرج! من مادّة تصقل عقل المتعلّم، تزرع فيه القيم والجمال، تفتح آفاقه على الحياة، تطلق مواهبه وتحفّز ملكات الإبداع لديه، (ولكلّ متعلّم قدرات إبداعيّة في جانب على الأقلّ) إلى مادّة مملّة (من دون تعميم) لا ترتبط بحياة المتعلّمين واهتماماتهم، وهي للحقّ - لو جرت مقاربتها بكفاءة تليق بها - حياة المتعلّمين ومسرح سعادتهم!
فهل فكّرتم في معنى أن يختفي فرع الآداب والإنسانيّات من التعليم ما قبل الجامعيّ؟
هل من حلول؟ دائماً ثمّة حلول، لو توافرت الإرادة، وقبلها المعرفة، وقبلهما المسؤوليّة! هذه الحلول كامنة في قلب المشكلة!
لذا، أدركوا فرع الآداب والإنسانيّات.